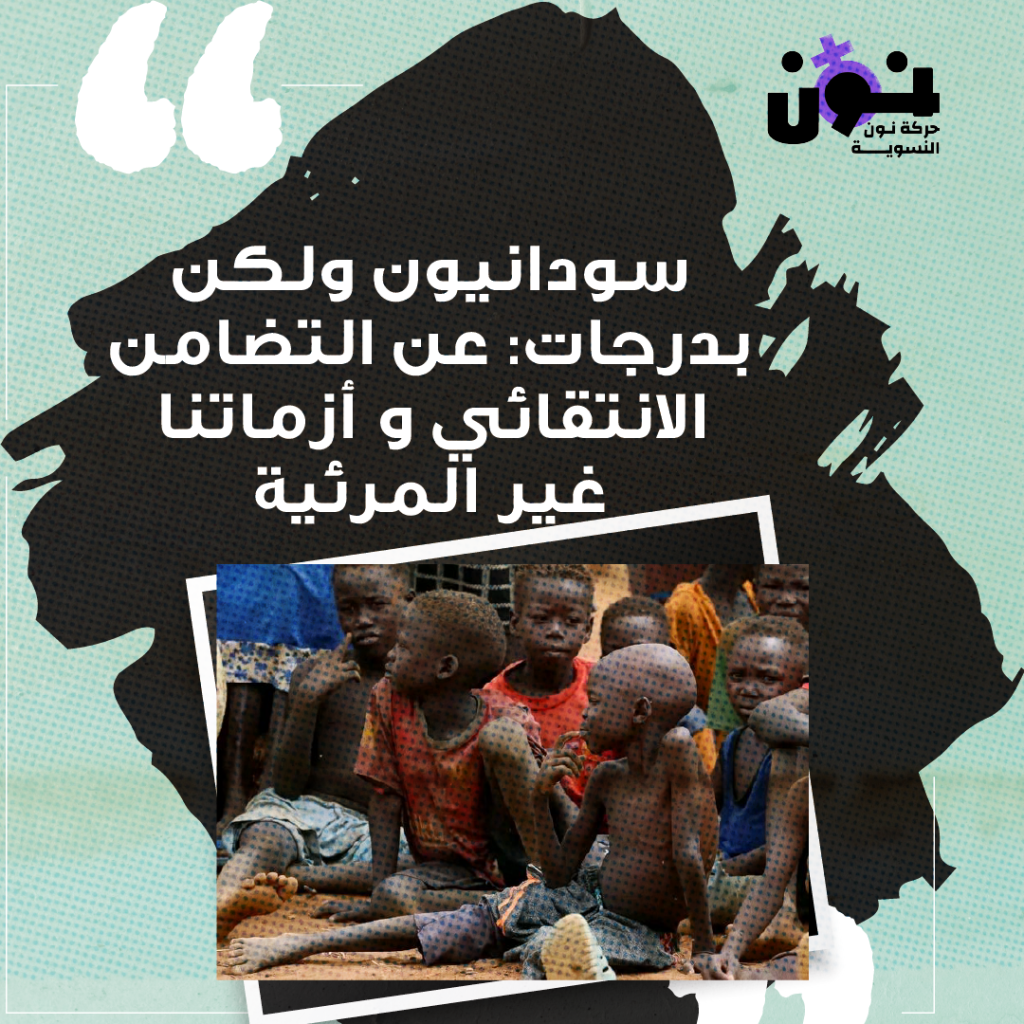في مشهد متكرر من التاريخ المعاصر، يُستخدم الجوع كسلاح. ليس فقط كأداة ضغط، بل كجزء من مشروع إبادة متعمد يستهدف جماعات بعينها، لا لشيء سوى لانتمائها العرقي أو السياسي أو الجغرافي. هذا ما يحدث في غزة. وهذا – بصمتٍ مطبق – ما يحدث أيضًا في السودان. بين أحياء غزة المحاصرة، حيث يُمنع الغذاء والدواء والماء، وبين جبال كادوقلي وأزقة الدلنج و مخيمات الفاشر التي تنهكها الحرب، يبرز التشابه القاسي: التجويع الممنهج، و الحصار، والاستهداف العرقي، وغياب العالم.
حرب على الوجود: التجويع كسلاح إبادة
في الحالتين – غزة والسودان – لا تقتصر الحرب على القنابل والرصاص، بل تتجاوزها إلى منع الإمدادات، وتدمير البنية التحتية، وتجفيف الموارد، وإغلاق الطرق. أطفال يموتون جوعًا، ومرضى لا يجدون علاجًا، وأمهات يرضعن القهر بدل الحليب.
في كادوقلي، كما وثقت جهات حقوقية وناشطون من الداخل، أُغُلِقت الطرق تمامًا، ومُنِعت الإمدادات، وارتفعت أسعار المواد الأساسية إلى مستويات خيالية، وسط غياب تام للمساعدات الإنسانية، ووسط حملات اعتقال ممنهجة تستهدف الناشطين والمواطنين على حد سواء.
في غزة، تتكرر نفس المأساة. الجوع ليس نتيجة جانبية للحرب، بل أداة مركزية فيها. حصار مُحكم، وقصف للمخابز، وتدمير للشبكات المائية، ومنع لدخول الغذاء والدواء.
من يتابع ما يجري في العالم اليوم لا يمكنه أن يغفل التفاوت الصارخ في حجم التعاطف والدعم الممنوحين لقضايا “العالم الأول” مقارنةً بتلك التي تخصّ “الجنوب العالمي” — وهو ما يكشف بوضوح أن التضامن ليس بريئًا، بل أداة سياسية تُستخدم بانتقائية. فبينما تُستنكر المجازر في مناطق معينة بشدة، تُقابل مجازر أخرى بالصمت أو “الحياد”. هذه ليست مصادفة، بل تعبير عن تراتبية غير معلنة في الأرواح: من يستحق التضامن، ومن لا يُرى.
السودان، كبلد يقع في قلب “الجنوب العالمي”، غالبًا ما يتم التعامل مع صراعاته باعتبارها “نزاعات داخلية”، أو “قبلية”، أو “معقدة أكثر من اللازم”، بينما تُعطى قضايا أخرى ذات الطابع الجيوسياسي الأوسع اهتمامًا أكبر.
ليس عالميًا فقط، بل محلي أيضًا
هذا التفاوت في التعاطف لا يأتي فقط من الخارج، بل يتجذر أيضًا في داخلنا كسودانيين. فكما تتجاهل الأنظمة العالمية معاناة الشعب السوداني غير المرئية سياسيًا أو إعلاميًا، يُعاد إنتاج المنطق نفسه داخل السودان. و كأن المركز قد ورث عن العالم خطابه عن “الهامش”، فصار يتعامل مع مآسي غرب السودان — في كادوقلي، الفاشر، الجنينة — وكأنها مشاهد مألوفة من مسلسل قديم، لا تُحرّك المشاعر بقدر ما تُضاف إلى أرشيف التكرار والتطبيع مع الألم.
ما يحدث في هذه المناطق لا يُحرّك الرأي العام في الخرطوم أو مدن السودان الأخرى كما تفعل معاناة غزة، رغم تشابه الأهوال، بل وتطابق بعض السياسات — كاستخدام الحصار و التجويع كسلاح حرب، وتهجير المدنيين كاستراتيجية عسكرية.
هذا لا يعني أن دعم غزة خطأ — بل هو واجب إنساني وأخلاقي لا لبس فيه — ولكنه يطرح سؤالًا مؤلمًا: لماذا لا تُقاس المآسي بنفس المعيار؟ لماذا تُصبح بعض الأرواح أحقّ بالنجدة من غيرها؟ وأين اختلت بوصلة الشعور الوطني؟
الخلل هنا ليس فقط في غياب التضامن، بل في البنية العاطفية التي تُحدِّد من هو “السوداني الكامل” ومن هو “الهامشي القابل للتجاهل”. إنه خلل في الوعي الجمعي، في خريطة الانتماء، وفي حدود ما نراه مستحقًا للحزن أو الغضب أو الفعل.
لماذا لا نشعر بهم؟: قراءة في الجذور التاريخية
هذا الانفصال في الشعور الوطني ليس وليد هذه الحرب فقط. إنه نتاج تراكم طويل من البنية المركزية في السودان الحديث، التي صممت الدولة والهوية الوطنية من عدسة ضيقة تمركزت حول الخرطوم، واختزلت الوطن في النخب النيلية، بينما تم تصوير المناطق الأخرى — غربًا وجنوبًا وشرقًا — كأطراف ملحقة، مهمتها إمداد المركز بالجنود، والذهب، والموارد، لا أكثر.
هذا النمط من التهميش كان واضحًا في الحرب الأهلية في الجنوب (1955–2005)، حين استمرت معاناة الجنوبيين لعقود، دون أن تجد تعاطفًا حقيقيًا في الشارع السوداني. عشرات الآلاف قُتلوا، مئات الآلاف شُردوا، ولم يكن لذلك أي أثر يُذكر في خطاب الإعلام أو الشعور الشعبي، بل كثيرًا ما كانت الحرب تُعرض على أنها “تمرد”، أو صراع ضد الدولة، مما يعني ضمناً أن القتل مشروع، لأن من يُقتل هو “الآخر”، وليس “نحن”.
تكرر الأمر نفسه مع دارفور. بين عامي 2003 و2010، كانت الإبادة الجماعية تمضي قُدمًا تحت بصر وسمع الحكومة، والمجتمع، والعالم. وفي الوقت الذي هزّت فيه صور اللاجئين والمقابر الجماعية ضمير المجتمع الدولي، ظل كثير من السودانيين يتعاملون مع القضية باعتبارها “نزاعًا قبليًا”، أو “تمردًا مسلحًا”، أو — في أحسن الأحوال — “مشكلة إنسانية” تقع هناك بعيدًا، في مكان ما لا نعرفه جيدًا، ولا نرتبط به وجدانيًا.
من أخطر ما يساهم في الفجوة العاطفية تجاه معاناة سكان الغرب السوداني هو انتشار سردية تبريرية تزعم أن بعض هؤلاء السكان “متعاونون مع الدعم السريع”. هذه الرواية تُسقط عن الضحايا صفتهم الإنسانية، وتحوّلهم إلى شركاء في الجريمة، ما يخلق مناخًا يُبرِّر التجاهل ويُجمّد أي شعور بالتعاطف.
هي سردية تُمارس عقابًا جماعيًا غير معلن، تُفرّق بين “المستحق وغير المستحق للشفقة”، وكأن إنقاذ الأرواح مرهون بولاء سياسي معيّن أو ببراءة افتراضية. وبهذا، تصبح المأساة قابلة للتفاوض، وتُحدّد قيمة الحياة وفقًا للموقع والانتماء، لا للكرامة الإنسانية.
هذه الرواية لا تنبع من فراغ، بل تمتد جذورها إلى تاريخ طويل من خطاب السلطة الذي ربط دائمًا “التمرد” بالهامش و”الوطنية” بالمركز. واليوم، تُعيد هذه السردية إنتاج ذلك الخطاب، لكن بلسان شعبي، فتُلبِس التجاهل ثوب الحذر، وتُحيل التضامن إلى رفاهية انتقائية.
خطرها لا يتوقف عند حدود الظلم الأخلاقي، بل يتجاوز إلى ما هو أعمق: إنها تُشرعن القتل والتجويع والتهجير عبر صمت متواطئ، وتُغلق أبواب أي مشروع وطني جامع. إذ ما جدوى الحديث عن وحدة البلاد إذا كنا نُفرّق بين دماء ضحاياها، ونزن مآسيهم بميزان الولاء؟
إن إعادة إنتاج هذه السردية في قلب الحرب الحالية ليس فقط انحدارًا أخلاقيًا، بل تهديد مباشر لإمكانية الخلاص، لأنها تُعمّق الشرخ التاريخي بين المركز والهامش، وتُقوّض أساس أي تعافي وطني محتمل.
إذًا، لماذا نتجاهلهم؟
- لأن التهميش التاريخي جعلنا نربط الوطن فقط بالمركز.
- لأن الرواية الرسمية طيلة عقود صاغت وعيًا مشوهًا عن الأطراف بوصفها “مشاكل” وليست “ناس”.
- لأن التعاطف لدينا ما زال انتقائيًا، ومبنيًا على قرب الجغرافيا، أو التشابه الطبقي، أو حتى الشكل.
- لأن الإعلام السوداني نفسه، المُدار من المركز، لا يغطي كادوقلي كما يغطي الخرطوم، ولا ينقل مشاهد الجوع في الفاشر كما ينقل خراب الحرب في العاصمة.
- لأننا لم نعتد رؤية أهلنا في الغرب كبشر يشبهوننا تمامًا، ويستحقون ما نطالب به لأنفسنا من أمان وكرامة.
هذا التراكم التاريخي من الإقصاء أنتج ما يمكن تسميته بـ “تبلد في الشعور” تجاه معاناة أجزاء واسعة من البلد. وهذا ليس فقط خللاً سياسيًا، بل خللًا في الضمير الجمعي، وفي فهمنا للوطن والمواطنة.
لا تكاد توجد حملات دعم لكادوقلي، أو الفاشر وقبلهما الجنينة. حتى التغطيات الإعلامية قليلة، خجولة، مقتضبة. قبل أسابيع، تظاهر عدد من المواطنين في أم درمان تضامنًا مع غزة. رفعوا اللافتات، وهتفوا ضد الحصار، ونددوا بالتجويع. التظاهرة كانت صادقة، مؤثرة، وتستحق الاحترام. لكن، هل يمكننا تخيل تظاهرة مشابهة تضامنًا مع كادوقلي؟ هل نستطيع – فعلًا – أن ننتفض لضحايا الحرب في غرب السودان بنفس الحماسة والصدق؟
المفارقة ذاتها تتكرر في مقارنة التفاعل السوداني مع ما حدث في ولاية الجزيرة وما جرى في الجنينة. في ديسمبر الماضي، عندما اجتاحت قوات الدعم السريع ولاية الجزيرة، عمّت موجة من الغضب والحزن، وأُطلقت دعوات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي للتنديد والاحتجاج، وتم تنظيم حملات إغاثة، وتصدر الخبر نشرات الأخبار وصفحات النشطاء. لم يكن هذا التفاعل خاطئًا، بل كان طبيعيًا وإنسانيًا. لكن في ذات الفترة تقريبًا، كانت مدينة الجنينة تعاني واحدة من أبشع المجازر في تاريخ السودان الحديث: قتل جماعي، اغتصاب، تهجير قسري، وانهيار كامل لمؤسسات الدولة والمجتمع. ورغم هول الجريمة، ظل الصمت سيد الموقف. لم تتحرك الشوارع، ولم تتصدر الصور، ولم تُطلق الحملات. وكأن المجزرة التي أُبيد فيها الآلاف لا تستحق حتى لحظة حداد أو دقيقة غضب. هذا التباين يطرح أسئلة مؤلمة عن انتقائية تعاطفنا، و توزيعنا الغريب للألم، و معاييرنا غير المعلنة لتحديد من “يستحق” التضامن ومن يمكن تجاهله.
ما نحتاجه ليس منافسة في المأساة، بل عدالة التضامن. لا يجب أن نختار بين غزة وكادوقلي، بل أن نوسّع أفقنا ليشمل كل المظلومين. أن نعي أن قضايا العدل مترابطة، وأن الاحتلال العسكري، والإبادة العرقية، والتجويع، والتهجير، ليست حكرًا على منطقة دون أخرى.
ما يحدث في السودان اليوم هو كارثة إنسانية، وإبادة صامتة، تجري في غياب شبه كامل للعدسة الدولية، وبتواطؤ صامت – أو نشط أحيانًا – من الداخل السوداني نفسه.
ختامًا: لنتحرر من الانتقاء
التضامن لا يجب أن يكون مرآة للسياسة، بل فعلًا أخلاقيًا حرًا. دعونا ننتصر لغزة بلا شروط، ولكن دعونا أيضًا نرى كادوقلي، الفاشر، الجنينة،نيالا، كأرض للإنسان، تستحق الحياة والكرامة.
فلعل أول خطوة نحو عدالة حقيقية في العالم، تبدأ من اعترافنا بآلامنا جميعًا، دون مفاضلة، ودون تبرير، ودون أن يضطر ضحايا اليوم أن “يثبتوا” أنهم بشر كي يستحقوا الحزن.
المصادر:
- https://web.facebook.com/100004083348608/posts/3998946603584745/?rdid=dee0OY5BQ3QglHrq#
- https://web.facebook.com/story.php?story_fbid=3699409196871822&id=100004083348608&rdid=XTPnanWHHR86Rocb#
- https://web.facebook.com/100064725493677/posts/1206596518174520/?rdid=L88GOqCAGNXxnAyj#
- Amid starvation in Gaza, Sudan, Guterres slams hunger ‘as a weapon of war’ | UN News
- Ashour Y, Abu‑Jlambo A, Abuzerr S. Starvation as a weapon of war in Gaza: violation of international law. The Lancet 2025; published online 20 May.
- Amnesty International. Gaza: Evidence points to Israel’s continued use of starvation to inflict genocide against Palestinians. Amnesty International, July 2025.
- OHCHR, “Using starvation as a weapon of war in Sudan must stop: UN experts”, press release, 26 June 2024, United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights.
- de Waal, A. (2024) ‘Hunger as a Weapon: A war strategy from Sudan to Gaza’, World Peace Foundation, 15 October.
- Agostini, N. (2025) ‘Sudan and the selective condemnation of double standards’, Geneva Solutions, 7 February (updated 18 February)
- Gerrit Kurtz, How (Not) to Talk About the War in Sudan, Megatrends Spotlight 30, Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), April 2024
- Friedman D. The ‘What about Sudan?’ trap. Jewish Chronicle (via JNS), May 2025
- https://web.facebook.com/sudannabaa/posts/تظاهر-عدد-من-المواطنين-في-أمدرمان-عقب-صلاة-الجمعة-تعبيرًا-عن-تضامنهم-مع-أهل-غزة-/122284290128022954/?_rdc=1&_rdr#
- https://web.facebook.com/watch/?v=1414637589772341